المغرب استطاع وضع أسس المدرسة التاريخية المغربية
هذا السؤال أول ما يطرأ على الذهن عندما يرد الحديث عن المجلات التاريخية في العالم العربي. ويستدعي هذا السؤال، بالضرورة، أسئلة أخرى جوهرية عن مدى ما حققته هذه المجلات والدوريات المتخصصة في الدراسات التاريخية في مجال تقدم هذه الدراسات على المستوى الأكاديمي، ومدى ما قدمته للباحثين والمؤرخين من خدمات لتطوير مجال دراستهم. المهم أن نشير هنا إلى عدة حقائق أساسية تتعلق بهذه المجلات: أولها أن «عمر» هذه «المجلات التاريخية» في الحياة الفكرية والثقافية العربية عمومًا قصير بالقياس إلى «السوابق» و«النماذج» الأوربية التي حاولت هذه المجلات تقليدها، وثانيتها: أن التوزيع المحدود جدًا لهذه المجلات والدوريات كان مقصورًا، في أحسن الأحوال، على الدوائر العلمية والأكاديمية في مجال البحث التاريخي، وثالثة هذه الحقائق، أن هذه المجلات والدوريات – حتى بعد تكاثرها – ظلت رهينة المحبين: ضعف الإمكانات المادية وضآلة عدد الجمهور الذي يطلبها.
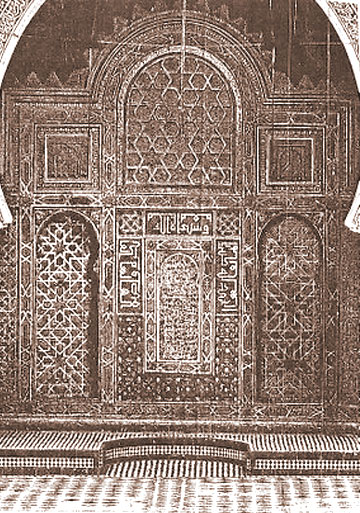
وإذا كان من المتفق عليه بصفة عامة أن مهمة المؤرخ أن يحاول العثور على إجابة السؤال الذي يبدأ بالكلمة السحرية «لماذا؟» فإن محاولة تطبيق هذه الفكرة أيضًا تستوجب النظر إلى المجلات والدوريات ذاتها في الوطن العربي من ناحية، ومدى وعي الناس بحقائق تاريخهم – في خطوطها العريضة على الأقل – من ناحية أخرى. بيد أن الإجابة على السؤال المطروح، والأسئلة التي تولدت عنه، تستحق منا أن نلقي نظرة على المسرح الذي ولدت فيه أولى «المجلات التاريخية» في العالم العربي، والتي باتت «السابقة»، و«النموذج» الذي قلدته المجلات التاريخية الأخرى التي ظهرت وكأنها من أفراخ المجلة الأم، مع استثناءات قليلة هنا وهناك.
كان ذلك المسرح الذي وُلدت عليه فكرة «المجلة التاريخية المصرية»، وتجسدت على خشبته واقعًا حيًا ملموسًا، يتسم بالإثارة والصخب من حيث الأحداث التي تجري ومن حيث الإطار العام أو المشهد العام الذي جرت فيه هذه الأحداث على السواء. وكان ذلك كله من نتائج الظروف التاريخية الموضوعية التي جرت على العالم العربي طوال القرن التاسع عشر وفي بدايات القرن العشرين. إذ كانت حركة الاستعمار الأوربي قد أحكمت قبضتها على سائر مناطق العالم العربي وأقاليمه إبان ذلك القرن. واقتسمت عدة دول استعمارية أوربية كعكة العالم العربي فيما بينها، وأعادت تقسيمها وتوزيعها فيما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية.
لقد كان الاحتلال واقعًا جديدًا غريبًا ومثيرًا بالنسبة لأبناء الوطن العربي، وكان الأمر بالنسبة لهم يختلف بشكل جذري عن الواقع الذي ألفوه في ظل الحكم العثماني منذ القرن السادس عشر. إذ إن قوى الاحتلال الأوربي كانت «العدو» التاريخي الذي عرفه التراث التاريخي العربي متراجعًا ومهزومًا إبان حركة الفتوح الإسلامية، وفي غمار أحداث الحروب الصليبية، وكان انتصاره في الأندلس قريب العهد، وفي مناطق نائية. ومن ناحية أخرى، كان ذلك الاحتلال الأوربي حدثًا غير مسبوق بالنسبة لأبناء المنطقة العربية، ومنذ بداياته الأولى في القرن التاسع عشر حرّك المياه الراكدة في بحيرة الثقافة العربية. وقد تمثل صدى هذا في شتى صنوف الاستجابات الثقافية والفكرية. ولم يكن التاريخ استثناء من ذلك الحال، بل ربما كانت الكتابات التاريخية هي الأبرز من بين هذه الاستجابات بسبب طبيعة التاريخ ذاته، وعلاقة الإنسان بالتاريخ.
فالتاريخ ممارسة ثقافية مفتوحة أمام الجميع. ودراسته لا تحتاج إلى تدريب خاص أو تمرينات معقدة، وإنما تحتاج إلى مهارات بسيطة يمكن لأي إنسان اكتسابها بقليل من الجهد الذاتي، ودون مساعدة خارجية متخصصة (ويبقى أن ما يميز مؤرخًا عن آخر هو الموهبة والقدرة على تلمس الحقائق من بين المصادر”
ولعل هذا كان السبب في أن الكتابات التاريخية التي ظهرت آنذاك كانت كلها مكتوبة بأقلام مفكرين لم يتخصصوا – بشكل أو بآخر – في الدراسات التاريخية.
وهكذا، كانت أحداث الاحتلال في كل بلد من البلاد العربية، وما أدت إليه من نتائج والمقاومة التي كانت ردود أفعال لممارسات الاحتلال، وللاحتلال ذاته، والأفراد العاديون والقادة والزعماء الذين انخرطوا في أعمال المقاومة، والإدارة الاستعمارية، وما جرى في شتى مجالات الحياة من جراء وجود الاحتلال الأوربي، وما إلى ذلك – كلها فتحت مجالات جديدة للكتابة التاريخية العربية، وأفرزت موضوعات جديدة لم يعرفها تراث التدوين التاريخي في العالم العربي من قبل. بيد أن أهم ما حدث في هذا المجال تمثل في «الدهشة» و«الصدمة» التي عبّرت عنها كتابات عبدالرحمن الجبرتي عن الحملة الفرنسية على مصر (1798 – 1801م)، وعلى الرغم من المبالغات المتكررة عن تأثير الحملة الفرنسية على الجانب الفكري والثقافي في مصر، فإن استمرار الهجوم الاستعماري النشط، ثم نجاح الاحتلال منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر في المغرب العربي (فرنسا)، ثم ما حدث في بلدان المشرق العربي (إنجلترا وفرنسا وإيطاليا)، كان هو الذي ترك الأثر الثقافي الخطير في العالم العربي ضمن التأثيرات الأخرى.
من جهة أخرى، كان النشاط الصهيوني المحموم في فلسطين منذ بدايات القرن التاسع عشر على الأقل، وثورات الفلسطينيين المتكررة، وممارسات سلطات الانتداب البريطاني لصالح المشروع الصهيوني، طوال الفترة السابقة على «النكبة الكبرى» وإعلان قيام دولة إسرائيل على الأرض العربية في فلسطين – كل هذا كان من عوامل حفز البحث التاريخي ضمن الحركة الفكرية والثقافية العامة التي هبّت رياحها على كل مناطق العالم العربي.
باختصار، كانت الظروف التاريخية الموضوعية التي تعرض لها العالم العربي منذ القرن التاسع عشر وراء الحركة الفكرية والثقافية التي أفرزت في نهاية الأمر – ضمن إفرازات أخرى كثيرة على عدة جوانب – الدراسة التاريخية الأكاديمية التي استوجبت بدورها ظهور المجلات التاريخية في معظم مناطق العالم العربي. فقد كانت الدولة العثمانية «الرجل المريض» في العيون الأوربية الاستعمارية النهمة، ولم تنتظر القوى الأوربية وفاة المريض لاقتسام تركته، بل استولت على أملاكه قبل الوفاة بزمن طويل. ومن هنا جاءت «صدمة الاحتلال» موازية لصدمة أخرى على المستوى الثقافي تعرض لها العرب الذين تم احتلال بلادهم في مشرق العالم العربي ومغربه. وقد تمثلت أهم نتائج هذه الصدمة الثقافية والفكرية بشكل إيجابي عندما انتبه العرب إلى أن هزيمتهم العسكرية والسياسية كانت نتيجة للفارق الحضاري الذي يفصل بينهم وبين الدول الاستعمارية الأوربية التي احتلت بلادهم.
كما أدركوا أن العالم الذي ألفوه وعاشوا في رحابه تحت الحكم العثماني قد ولّى زمانه إلى غير رجعة، وأن الأوربيين سبقوهم في مضمار الحضارة والتقدم بفارق كبير.
كان طبيعيًا أن يحاول أبناء النخب العربية في المشرق والمغرب سدّ الفجوة الحضارية بينهم وبين الغرب الأوربي، مستفيدين من تجارب مهمة في هذا السبيل جرت في مصر والشام في عصر محمد علي باشا، ثم محاولات حفيده الخديو إسماعيل، والمحاولات الأخرى الموازية التي جرت في تونس أو سورية ولبنان أو العراق… أو غيرهما. ولأن أبناء النخب العربية أدركوا أن موازين القوة العسكرية، والتوازنات السياسية، والقدرة الاقتصادية، لم تكن في مصلحتهم (على الرغم من أن ذلك لم يمنع حركات الكفاح المسلح، ومحاولات تنمية القدرات الاقتصادية، ومناورات الحركة السياسية) فإن فريقًا منهم اختار النضال في مجال الفكر والثقافة والعلم. وعلى الرغم من أن النضال السياسي والكفاح العسكري كان الأعلى صوتًا، فإن نضال أبناء النخب العربية في مجال الفكر والثقافة والعلم كان أبقى أثرًا من ناحية، كما كان دعمًا وسندًا للكفاح المسلح والنضال السياسي من ناحية ثانية، فضلاً عن أن نتائجه ظلت قائمة على الأرض العربية حتى بعد رحيل الاستعمار من ناحية ثالثة.
لقد كان النضال الثقافي والفكري والعلمي من جانب أبناء النخب العربية في جوهره بحثًا عن الخلاص، وسعيًا وراء الحل لأزمة التخلف العربي. ولكن اللافت للنظر أن هذا البحث وهذا السعي وراء الخلاص من السيطرة الأوربية كان في رحاب الفكر والثقافة الأوربية ذاتها. لقد كان بحث «المغلوب» عن حل أزمته عند «الغالب». فالمغلوب دائمًا مولع بتقليد الغالب، وهذه سنة تاريخية راسخة وحقيقية أيضًا. وكان طبيعيًا أن يحاول الباحثون عن الحل لأزمتهم أن يجدوا هذا «الحل» لدى أوربا. ومن هنا ذهبت البعثات، والأفراد، وأقيمت المؤسسات العلمية والثقافية – بل والسياسية – على غرار مثيلاتها في أوربا. فقد كانت المجلات والصحف، والمسارح ودور السينما، والندوات والمؤتمرات والاجتماعات، والجمعيات العلمية بشتى أنواعها، والجامعات – كلها تقليدًا محمودًا لنماذج أوربية. وتشهد مذكرات الرواد من المفكرين والباحثين والأدباء والفنانين العرب، ويومياتهم، عن الرحلة إلى أوربا بهذا القدر الكبير من الافتتان بالحضارة الأوربية، وتجليات الحياة الفكرية والثقافية هناك، ومدى الولع بتقليدها باعتبارها طريقًا للخلاص. كانت هناك – بطبيعة الحال – مظاهر سلبية عديدة لتقليد أوربا، ولاسيما في مجال السلوك الاجتماعي لأبناء الشرائح العليا في المجتمعات العربية، ولكن هذا ليس مجال اهتمامنا في هذه الورقة على أي حال
كان أهم هذه التجليات الفكرية والعلمية والثقافية لنضال الشعوب العربية، إنشاء الجامعة المصرية في العقد الأول من القرن العشرين. وفي ظني أنه كان أهم حدث في التاريخ الفكري والثقافي في العالم العربي في العصر الحديث (لأن الجامعة المصرية كانت بؤرة التفاعل الثقافي العربي، كما تربت فيها أجيال من المفكرين العرب، فضلاً عن أنها صارت نموذجًا أنشئت على مثاله الجامعات العربية الأولى في بغداد ودمشق وغيرها، كما أنها خرجت أجيالاً من الأساتذة والمفكرين الذين ساعدوا على إنشاء جامعات كثيرة بعد ذلك في مصر وغيرها من البلاد العربية) لقد تأسست الجامعة المصرية، بمبادرة أهلية وباعتبارها أداة نضال ضد الاستعمار البريطاني في مصر سنة 1908م، ثم تحوّلت إلى جامعة حكومية سنة 1925م، ويهمنا هنا أن نركز على مدى تأثير الجامعة على الدراسات التاريخية بصفة خاصة، مع اعترافنا بأهمية ما قدمته في المجالات الأخرى بطبيعة الحال كانت كلية الآداب في الجامعة المصرية، ثم جامعة فؤاد الأول، من أولى الكليات التي قامت الجامعة عليها، ومنذ بداية هذه الكلية حظيت الدراسات التاريخية فيها بحظ وافر، فقد كان قسم التاريخ واحدًا من الأقسام الخمسة التي ضمتها الكلية عند نشأتها.
فقد ضمت كلية الآداب خمسة أقسام: التاريخ، واللغة العربية، واللغات الشرقية، واللغات الأوربية والفلسفة ويهمنا في هذا المجال أن نشير إلى أن الدراسة التاريخية الأكاديمية، بمعناها الحديث قد نشأت للمرة الأولى في العالم العربي، بقسم التاريخ بالجامعة المصرية (جامعة فؤاد الأول ثم جامعة القاهرة)، وهو ما جعل الدراسات التاريخية تنعطف منعطفًا جديدًا في القرن العشرين. بيد أن أهم نتائج هذا التحول الجديد في اتجاه الدراسات التاريخية، في رأيي، تمثلت في ظهور المؤرخ المحترف (أي الذي يتخذ من البحث التاريخي وتدريس التاريخ مهمة يكرّس حياته لها، ويكسب عيشه منها)، وعلى الرغم من أن هذا لم يمنع ظهور مؤرخين موهوبين ممن لم يتخذوا التاريخ مهنة لهم، فإن ظهور «المؤرخ المحترف» للمرة الأولى في الحياة الفكرية العربية أدى إلى نتائج غاية في الأهمية. فقد بدأ يظهر بين صفوف المؤرخين المحترفين شعور بالذات جعلهم يتطلعون إلى تأكيد هويتهم من خلال الجمعيات التاريخية، والمجلات التي تحمل ثمار عملهم في مجال تخصصهم، رغبة منهم في التمايز عن زملائهم المتخصصين في فروع المعرفة الأخرى وربما يكون من المهم أن نشير هنا إلى أن ظهور المؤرخ المحترف في الفضاء الفكري العربي لا يعني بالضرورة أن المؤرخين من خارج الأكاديمية كانوا من الهواة حسبما ظن البعض.
فالمؤرخ هو المؤرخ بغض النظر عن مهنته، وقدراته العلمية ومواهبه هي المعيار الوحيد لتميزه عن غيره من ناحية أخرى، كانت إسهامات المؤرخين العرب، من غير المحترفين (بالمعنى الذي أشرنا إليه في السطور السابقة) في النصف الأول من القرن العشرين، والمصريون منهم بوجه خاص، قد حملت بصمة المؤثرات الأوربية في الفكر التاريخي. ولكن كتابات أولئك المؤرخين لم تخضع تمامًا لهذه المؤثرات لأن أنفاس التراث العربي في مجال الكتابة التاريخية كانت مازالت تتردد في ثنايا كتابات أولئك المؤرخين، الذين كانوا بمنزلة الجسر الواصل بين أصحاب الكتب والمؤلفات التاريخية في القرن التاسع عشر، من أمثال عبدالرحمن الجبرتي، وعلي مبارك، ورفاعة الطهطاوي، وفيليب جلاد، ويعقوب آرتين، وسليم نقاش (في لبنان)، وميخائيل شارويم، ونقولا الترك.. وغيره من ناحية، والمؤرخين الذين تتلمذوا على أيدي الأوربيين من ناحية أخرى.
وربما يكون مفيدًا في هذا السياق أن نشير إلى أن بداية الدراسة الأكاديمية للتاريخ في العالم العربي كانت موصومة في بعض الفترات بتبعية هذه الدراسة لفكرة التاريخ الأوربي، وتقسيم الزمن التاريخي حسب الرؤية الأوربية. فقد ظل قسم التاريخ بجامعة فؤاد الأول (القاهرة) تحت رئاسة الأساتذة الأجانب، وتوجيههم، حتى سنة 1936م، وإن ظلت بصمتهم باقية حتى الآن في تقسيم العصور التاريخية، وتنظيم مناهج الدراسة. وما نتج عن هذا، بطبيعة الحال، من مشكلات مازالت الدراسات التاريخية تعاني منها في شتى أنحاء العالم العربي.
ومن ثم جاءت الدراسة التاريخية في مصر، وفي العالم العربي عمومًا، وكأنها فرخ من أفراخ الدراسات التاريخية الأوربية. وبغض النظر عن النتائج والآثار السلبية العديد لهذه الحقيقة «التاريخية»، فإن تأثير الأساتذة الأجانب كانت له جوانبه الإيجابية أيضًا.
فقد ظهرت في الأجيال التالية محاولات جادة لتعريب «التاريخ»: أي محاولة «قراءة» التاريخ من وجهة نظر عربية ومصرية أسهم فيها المؤرخون المحترفون وغير المحترفين معًا. وظهر عدد من المؤرخين الذين كان طموحهم يدفعهم إلى محاولة بناء «مدرسة تاريخية» عربية يكون قوامها ذلك العدد المتزايد من المؤرخين العرب «المحترفين» الذين تخرجوا من أقسام التاريخ في الجامعة العربية المتزايدة في كل قطر من أقطار العالم العربي إلى جانب نفر من المؤرخين الذين كانت كتاباتهم تجديدًا مثيرًا ومفيدًا أفادت منه الدوائر الأكاديمية في مجال الدراسة التاريخية كثيرًا. وحاول الكثير من المؤرخين العرب تصحيح الأخطاء والخطايا الناجمة عن اتباع خطى المؤرخين الأوربيين، والأخذ بمفاهيمهم، وعدم فهم انحيازاتهم التاريخية.
كان إنشاء الجمعية المصرية للدراسات التاريخية (الجمعية التاريخية الملكية) في النصف الأول من القرن العشرين بالقاهرة أولى الخطوات الجادة والناجحة في هذا السبيل. وقد كان الفضل في إنشاء هذه الجمعية راجعًا إلى عدد من رواد الدراسات التاريخية المصريين ولقوا مساندة مهمة من أبناء النخبة المصرية ولاسيما من أبناء الأسرة الملكية الحاكمة آنذاك. وكانت أهم أهداف هذه الجمعية ترقية البحث التاريخي، والعمل على تطور الدراسات التاريخية في العالم العربي. ومن الطبيعي أن تضم هذه الجمعية في عضويتها، على مدى أجيال متعاقبة، عددًا كبيرًا من المؤرخين العرب، والمهتمين بالدراسات التاريخية العربية. ومن ناحية أخرى، أصدرت الجمعية المصرية «المجلة التاريخية المصرية» لتكون أول مجلة مصرية عربية تحتضن جهود المؤرخين العرب في تطوير البحث التاريخي في العالم العربي من ناحية، ونشر ثمار الدراسة الأكاديمية من ناحية ثانية، وإثارة وعي النخبة بتاريخها من ناحية ثالثة. وقد لعبت هذه المجلة دورًا مهمًا في ميدان الدراسة التاريخية وفتحت صفحاتها للدراسات الجديدة في فروع الدراسات التاريخية الجديدة التي ارتادها المؤرخون والباحثون العرب.
ويكشف أي جهد إحصائي في فهارس الأعداد التي صدرت من «المجلة التاريخية المصرية» عن أن كتّابها من الباحثين العرب، على مرّ الأجيال، قد طرقوا أبواب البحث في التاريخ السياسي، والتاريخ الاجتماعي، والتاريخ الاقتصادي، والتاريخ العسكري، وتاريخ الفن، والتاريخ الفكري.. وهلم جرا. بل إن صفحات المجلة استضافت البحوث التي تتناول الآثار على اعتبار أن مجال التاريخ ومجال الآثار مرتبطان ارتباطًا عضويًا. وبالإضافة إلى هذا التنوع المثير في الموضوعات التي ضمتها صفحات المجلة المصرية التاريخية، فإنها كانت تقيم في كل سنة حلقة نقاشية حول أحد الموضوعات المهمة ويتم نشرها في كتاب مستقل، ومن أهم ما أصدرته «الجمعية التاريخية المصرية» في هذا الصدد تلك المجموعات من الدراسات عن المؤرخين العرب عن الكتابة التاريخية العربية بشكل عام: فقد صدرت مجلدات مهمة عن ابن عبدالحكم، والمقريزي، وابن إياس.. وغيرهم. كما أن الدراسات التي تتناول مناطق التداخل بين التاريخ وغيره من فروع المعرفة، مثل الاجتماع، والسياسة والاقتصاد والفن والآثار وغيرها، لقيت المزيد من اهتمام المجلة التاريخية المصرية بحيث ضمت أعدادها على مر السنين بحوثًا ودراسات كثيرة في هذه الميادين، بل إنها ضمت دراسات عن العلاقة بين الشعر والتاريخ، والأدب والتاريخ بشكل عام بدأت تظهر على استحياء في هذه المجلة العريقة.
ولأن «المجلة التاريخية المصرية»، تحمل جزءًا مهمًا من «تاريخ» الدراسة التاريخية في مصر، وفي العالم العربي بشكل عام، فإنها عكست التطورات الفكرية التي جرت على الساحة المصرية والعربية في النصف الثاني من القرن العشرين. إذ كان من الطبيعي بعد ثورة 1952، وتصاعد المد القومي العربي من ناحية، وبروز الاهتمام بالشعب وطبقاته الفقيرة بشكل خاص من ناحية أخرى، أن يتجه البحث التاريخي بعيدًا عن المدرسة الليبرالية القديمة التي كانت تمجد الفرد الحاكم، وتأخذ بنظرية البطل في التاريخ. وبدأ جيل المؤرخين الذي برز في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين يبحث في أحوال العمال والفلاحين، وبدأت دراسات التاريخ الاقتصادي والتاريخ الاجتماعي لأبناء هذه الطبقات تنتشر على صفحات المجلة. ومن ناحية أخرى، أدى تصاعد المد القومي العربي إلى إعادة النظر في الكثير من المسلمات التي كانت سائدة بشأن التاريخ العربي القديم، والحضارة العربية الإسلامية، والحروب الصليبية… وما إلى ذلك. كما تنوعت الدراسات التاريخية من حيث الكيف تنوعًا كبيرًا، واقتحمت مناطق عديدة لم تكن مطروقة من قبل. فقد ظهرت فروع الدراسات التاريخية واضحة جلية على صفحاتها وانعكس دورها الإيجابي على التنوع المذهب في موضوعات الدراسات التاريخية التي تناولتها رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية والعربية.

