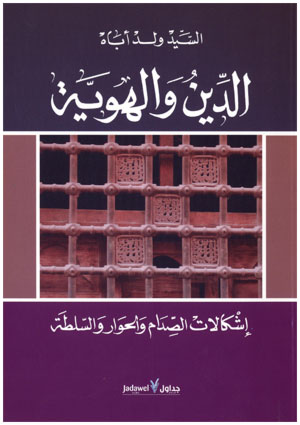
يُحكى عن الفيلسوف الفرنسي ميشال سر، أنه عندما كان يريد في السبعينات إثارة اهتمام طلبته حدثهم في السياسة، وعندما كان يريد الترفيه الهزلي عنهم حدثهم في الدين، وقد انعكست الصورة راهنا فلم تعد السياسة سوى مادة للسخرية والاستهزاء، وتحول الدين إلى واجهة الاهتمام الفكري والنظري.
لم نجد أفضل من هذه المقولة التي أوردها السيد ولد أباه، في معرض الترحال مع عرض ثنايا آخر أعماله، ويحمل عنوان: “الدين والهوية.. إشكاليات الصدام والحوار والسلطة”، مع أنه عبارة عن تجميع لمجموعة من الدراسات والمقالات، نُشر بعضها سابقا في بعض الدوريات الفكرية، أو كان بعضها الآخر إسهامات في ملتقيات وندوات، إضافة إلى فصل خاص بنظرة الإسلاميين إلى الحداثة (في أصله مقالات صدرت سنة 2004 في يومية “الشرق الأوسط” اللندنية)، لولا أن جدة النظر والتأمل تشفعان للقارئ تزكية الحديث عن كتاب قيّم. (صدر العمل عن دار جداول، بيروت، ط 1، 2010، 144 صفحة).
جاءت محاور الكتاب موزعة على سبعة فصول:
المسالة الدينية – السياسية بين الدولة الدينية والدولة – اليدين؛ المسالة الدينية – السياسية في ما وراء حجاب العلمانية؛ الفكر السياسي الشيعي المعاضر، نموذج ولاية الفقيه: الخلفية الفكرية والمأزق الراهن؛ الحداثة والكونية: إشكالية الخصوصية؛ الحداثة في الخطاب الإسلامي (وتضمن الأبواب التالية: محمد قطب.. التنوير المفترى عليه، سفر الحوالي. الحداثة والدين، عوض القرني.. محاكمة الحداثة، عبد الوهاب المسيري.. القطبية الجديدة)؛ الإسلاموفوبيا الجديدة (الاستراتيجية والدينية والعالمة؛ الإسلاموفوبيا نزعة عنصرية لا فكرية)؛ وأخيرا، الفصل السابع الذي يحمل عنوان: الحوار الديني، الخلفيات الفكرية والاستراتيجية.
وعلى الرغم من اختلاف هذه الفصول في الموضوعات، فإنها تصدر عن محور واحد، هو النظر في إشكالية “الدين والهوية” من مداخل متعددة:
1- المسألة الدينية – السياسية وأثرها في تشكيل الهوية الثقافية وفي مسائل الشرعية والإيديولوجيا؛ حيث يرى المؤلف أن الخطأ الجلل الذي تقع فيه أغلب اتجاهات الفكر الإسلامي، هو محاولة أسلمة الدولة الوطنية الحديثة من دون الوعي بأنها تستبطن الوظائف العمومية التقليدية للدين؛
2- سؤال الكونية والاختلاف واستتباعاته على مستوى النظرة إلى الذات وإلى الآخر؛ حيث يعرض الكاتب للمواقف من الحداثة والعولمة، لا سيما في السياق العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن نهج الخطاب العربي السائد حاليا يميل، غما إلى اختزال العولمة يف واقع الهيمنة الأمريكية، أو ما يدعى بالنظام العالمي الجديد، وإما إلى إعطائها هالة نموذج حضاري جاهز للتصدير؛ مما ينم عن تصور فادح في استكناه تحولات نوعية تطال البشرية برمتها، وتستهدفها بمقوماتها الأنطولوجيا والمعرفية والسلوكية.
3- الإسلاموفوبيا الجديدة: رهاناتها الفكرية والاستراتيجية، ومقومات الحوار الديني، وهو الذي سوف نتوقف عنده بالتفصيل في هذا العرض.
إسلاموفوبيا أم إسلاموفوبيات…
بالتوقف إذا عند موضوع الإسلاموفوبيا، يلاحظ المؤلف أن ما نشاهده راهنا هو بروز نمط جديد من الإسلاموفوبيا، حيث يوزعه على اتجاهات خمسة، هي: الإسلاموفوبيا الإستراتيجية، و الإسلاموفوبيا الدينية، و الإسلاموفوبيا العالمية، بالإضافة إلى التيار الأدبي الإنكليزي، الذي أطلق عليه ضياء الدين سردار عبارة “المحافظين الأدبيين البريطانيين”، والمفكرين اليساريين الفرنسيين المنحدرين من مجموعة “الفلاسفة الجدد”، الذين تحولوا في الآونة الأخيرة إلى الموقع المحافظ، ودعموا الرئيس اليمني السابق نيكولا ساركوزي.
فيما يتعلق بالإسلاموفوبيا الإستراتيجية، فقد ظهرت بقوة بعد نهاية الحرب الباردة، وتجدرت بعد أحداث 11 شتنبر 2001. وتتمحور هذه الصيغة من الإسلاموفوبيا حول “الخطر” الذي يشكله القضاء الإسلامي، عقيدة ومجالا، على المنظومة الغربية، وقد رصد الكاتب الهندي “بانكاج ميشرا” في دراسة متميزة جديدة الظاهرة عبر أخر الإصدارات التي تناولت “الخطر الإسلامي”. ومن هذه النماذج الصحافي الأمريكي “كريستوفر كالدويل” الذي أصدر مؤخرا كتابا مثيرا بعنوان “تأملات حول الثورة في أوروبا: الإسلام والغرب”، قارن فيه بين وجود الجاليات المسلمة في أوروبا والحزب البولشيفي في روسيا قبل اندلاع الثورة الشيوعية 1917، معتبرا أن الثقافات “المتقدمة” كثيرا ما قللت من شأن الخطر الذي يتهددها من قبل الثقافات “البدائية”.
بالنسبة للإسلاموفوبيا الدينية، فتشكل في جانب منها أثرا لأدبيات الصراع الديني الوسيط، لكنها توظف راهنا في معادلة مغايرة وسياق جديد مختلف. وأبرز تجلياتها محاضرة البابا بنديكت السادس عشر المشهورة في جامعة ريغنسبورغ الألمانية عام 2006 التي قارن فيها بين الإسلام والمسيحية، ومن حيث القدرة على التوفيق بين الإيمان والعقل، منتهيا إلى وسم الإسلام بالنزوع العدواني ورفض المنهج العقلي.
أما عبارة “الإسلاموفوبيا العالمة”، فقد اقتبسها المؤلف من عنوان كتاب أصدره في فرنسا بعض أبرز المختصين في الفلسفة والعلوم الإسلامية الوسيطة: فيليب بوتغن، وألان دليبرا، ومروان راشد، وإبرين روزيه كاتاش. والكتاب في عمومه رد على كتاب مثير للجدل صدر عام 2008م بقلم “سليفان غوجنهايم” حول الأصول الإغريقية لأوروبا المسيحية، ويتمحور كتاب “غوجنهايم” حول فكرة رئيسية هي إنكار أي دور للعرب والمسلمين في نقل التراث اليوناني إلى الغرب الحديث، بل نفي أي إسهام للعلماء والفلاسفة المسلمين في حركية الحداثة، فالبنسبة إليه، تقابلت الحضارتين الإسلامية والغربية المسيحية منذ العصور الوسطى، ولم يكن لأي منهما تأثير جوهري في الأخرى، وقد أثار الكتاب ضجة هائلة في البلدان الغربية، وخصصت له اليوميات الفرنسية الرئيسية الثلاث (“لوموند” و”لوفيغارو” و”ليبراسيون”) ملفات خاصة، واحتفت به الدوائر المتطرفة المعادية للعرب والمسلمين، لولا أننا نسجل بارتياح أن 56 من كبار المؤرخين والعلماء الغربيين، أصدروا في عدد من كبريات الصحف الغربية بيانا علميا رفيع المستوى رد بكل دقة وجلاء على ترهات غوجنهايم. وقد حمل البيان عنوان “نعم، الغرب مدين للعالم الإسلامي” وأوضح أن الكاتب سقط في أغلاط علمية قاتلة مصدرها العماء الأيديولوجي، مستغربا اتهامه الثقافة الإسلامية بالجمود لأسباب عقدية مع تبرئة المسيحية من هذا الحكم، مع أن اكتشافات العرب في مجالات الفلك والرياضيات وغيرهما، كانت أهم بكثير من الإسهام الروماني، الذي اعتبره المؤلف القنطرة الواصلة بين التراث اليوناني والحضارة الأوروبية الحديثة.
وهكذا يُفند مؤلفوا كتاب “الإغريق، العرب ونحن: تحقيق حول الإسلاموفوبيا العالمة”، هذه الأطروحة المتهافتة بالأدلة العلمية الموضوعية التي لا تقبل الجدل، معتبرين أنها لا تستحق أن نطلق عليها حتى مجرد الفرضية العلمية، وإنما هي أثر لأيديولوجيا عنصرية عدوانية تقوم على إسقاطات تاريخية واهية. ويُفسر المؤلفون الترحيب الواسع الذي لقيه الكتاب على الرغم من ضحالته بمناخ فكري جديد في فرنسا تعبر عنه “فلسفة التاريخ الساركوزية” التي تتبلور في ثلاثة محاور رئيسية متمايزة، هي:
– الاحتفاء بالجذور المسيحية المحضة لفرنسا، والدعوة إلى مراجعة خط العلمانية الجمهورية القائمة لإعادة الاعتبار لهذه الهوية الدينية المسكوت عنها في الثقافة السياسية السائدة ، مما يشكل نغمة جديدة غريبة عن خطاب السامة الفرنسيين.
– الدعوة إلى إعادة الاعتبار للتجربة الاستعمارية، من حيث كونها تحتوي عناصر “إيجابية” يتعين التنبيه إليها في المناهج التربوية، مما يذكر بالأدبيات الاستعمارية القديمة في حديثها عن “تمدين الشعوب المتوحشة” تبريرا للاحتلال والاستيطان.
– النزوع إلى محو آثار “ثورة مايو 1968” التي نسفت القاعدة النظرية والأيديولوجية لليمين المحافظ، وفتحت آفاقا رحبة للخطاب النقدي الرافض للمركزية الثقافية والمنفتح على السياقات المغايرة المختلفة.
مقتضيات الحوار بين أتباع الديانات
نختم هذا العرض بالتوقف العابر عند رؤى الكاتب لموضوع الحوار بين الأديان، مقرا بداية أن مخزون المعنى والرصيد القيمي في الديانتين الذي يحتاج إليه عالمنا اليوم، الذي انهارت فيه النزعة الإنسانية، إثر مصائب ومآسي القرن العشرين، وانحسار زخم عقيدة حقوق الإنسان، وشيوع الأيديولوجيات العدمية التي بشرت بموت الإنسان وعليه، فالإنسان الذي اختزل اليوم في الكائن الاستهلاكي بحاجة إلى الرصيد الديني لإعادة شحذ وتعبئة مخزونه القيمي.
وفي هذا السياق، يُفرق الكاتب بين مقدمتين أساسيتين، قبل الحديث عن حوار جدي بين أتباع الديانات السماوية، وجاءت كالتالي:
1- نلمس بداية عدم الوعي بالفوارق المميزة بين حضور الدين في السياقين الإسلامي والغربي. ففي السياق الإسلامي لا يزال الدين يشكل المركز الثقافي الأعمق والجذر العقدي الفاعل في البنية الاجتماعية، وله تأثيره الديناميكي في الحقل العام، على عكس المجتمعات العلمانية الغربية، حيث لا يتجاوز تأثيره السلوك الفردي والأرضية الرمزية البعيدة، فلا دور له في صياغة القيم الجماعية، ولا أثر له في الشأن العمومي.
2- وثانيا، من الضروري الانطلاق من مصادرة ثنائية التقليد اليهودي ــ المسيحي المشترك والخصوصية الإسلامية، لأنه من المعروف أن هذه المصادرة نشأت في الخطاب الاستشراقي المناوئ للإسلام، وأريد بها إقصاؤه من التقليد الكتابي التوحيدي ومن الإطار المرجعي للثقافة الغربية. وغني عن البيان أن الإسلام على خصوصياته يندرج في التقليد نفسه الذي هو خاتمته ونقطة اكتماله.
مثل هذه المقدمات وغيرها بالطبع، تبرر إطلاق فكرة حوار ديني، يتطلب لكي يكون ناجعا إخراجه من الحوارات الميتافيزيقية والكلامية إلى إشكالات ومقتضيات التعايش والتعاون. فالمطلوب هو بلورة نمط من “الدبلوماسية الدينية” بدل الحوار العقدي اللاهوتي، ويعني بهذه المقولة توجيه النظر إلى دور الدين انتماء وثقافة في السياقات الإستراتيجية والسياسية الدولية، مما نلاحظه في مستويات عديدة يتعين الإشارة إلى بعضها. فمن الواضح أن الوعي يتزايد بأهمية توظيف الدين في العلاقات الدولية حتى في البلدان العلمانية العريقة، ولا يعني المؤلف هنا النظر في حضور العامل الديني في السياسات العامة والشؤون الداخلية، بل ببروزه كأحد بنود الأجندة الرئيسية في العلاقات الدولية، مما يشكل من دون شك نقطة تحول في فلسفة التصورات الدبلوماسية.
منتصر حمادة

